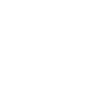بين الظلمة والنور - الكاتبة إيمان أبو شاهين يوسف

الكاتبة والباحثة
الاستاذة إيمان أبو شاهين يوسف
في ليلة أثقلها الظلام وصار السواد فيها مادة لا فراغ ، سمعت حركة غامضة تتسلل من الخارج، أصواتاً متقطعة وخشنة أيقظت في داخلي خوفاً لم أعرف له إسماً.
بقيت ساكناً للحظة، أصغي...، وكل صوت جديد كان يبدو أقرب من سابقه. إقتربت من الستارة بحذر، مددت يدي وكأنني أمدها نحو مجهول لا أريد لمسه، أبعدت الستارة قليلاً واسترقت النظر من شقٍ ضيِّق، فارتسم لي هناك في العتمة شبح عملاق يحرِّك يديه بإشارات حادة، وكأنه يصدر أوامر لمجموعة من الأشباح كي تتقدم.
ثمّ رفع رأسه إلى الأعلى وفتح عينيه على وسعهما، كما لو كان يتحقق من وصول سربٍ من كائنات غير مرئية.
شعرت بأن المكان لم يعد يتسع لي من شدة خوفي. أغلقت الستارة بسرعة، وتراجعت الى الخزانة المركونة الى حائط غرفتي، دخلتها وأغلقت بابها خلفي، غطيت نفسي بكل ما طالته يداي من ثياب، وحبست أنفاسي كأن الصوت قد يكون دليلا على وجودي. مرّت الساعات ثقيلة خانقة، والوقت في ذلك الضيق فَقَدَ معناه. ثمّ تسلل إلى جسدي إحساس غريب، كدفع خفيف أو حركة قريبة. ارتعدت من الخوف، وظننت أن الأشباح اكتشفت مخبئي. تراخى جسدي، وضاق نَفَسي، ولم أعد قادراً على المقاومة.
دقائق مرّت، ثمّ فجأة أضاء كل شيء من حولي. دخل الهواء إلى صدري بقوة، تنفست الصعداء وقلت في سرّي: لقد جاء الصباح، وانسحب الظلام، ولا بدّ أن الأشباح قد انسحبت معه.
رفعت طبقات الثياب عنّي، خرجت من الخزانة ببطء وتقدّمت نحو الستارة. من خلفها عدت أسترق النظر. وما أرعبني في الليل لم يكن سوى أغصان الأشجار، مثقلة بأوراقها الخضراء وأزهارها الوردية.
كان النسيم يداعبها بلطف، فتلتفُّ حيناً حول جذع أمّها الشجرة، ثمّ تنبسط حيناً آخر، كأنها تحتفل بحركة الهواء.
أما الأزهار فكانت تلمع مع كل اهتزاز، ومع كل نسمة تطلق عبيرها فيفوح العطر وينعش المكان بشذاه.
عند تلك اللحظة، لم ينته المشهد، بل بدأ السؤال: كيف تحوَّل ما رأيته ليلاً إلى شيءٍ مختلف تماماً في الصباح؟
هل تغيَّرّت الأشياء أم تغيَّرت عيناي؟ هل كان الشبح موجوداً حقّاً، أم أن الظلام كان شريكاً في صناعته؟ لماذا بدا الخوف حقيقيّاً إلى هذا الحد، مع أن مصدره لم يكن سوى أغصان تتمايل؟
وهل ما نراه في العتمة هو إنعاش لما يختبئ في أعماقنا أكثر مما هو صورة لما في الخارج؟
ثمّ بَرَزَ سؤال آخر أشد إلحاح: هل النور يكشف الحقيقة أم يُبَدِّل زاوية النظر فقط؟ وإذا كان الشيء الواحد قادراً على أن يكون مرعباً وجميلاً في آن واحد فبِمَ نحكم عليه؟ وهل الجمال كامن في الأشياء بذاتها أم أنّه يولدُ من البيئة التي تحيط به ومن الضوء الذي يغمره؟ لعلَّ ما نخافه ليس هو العالم ، بل الصورة التي نصنعها عنه حين نفتقد الوضوح؟ وهكذا لا تقودنا القصة الى حقيقة واحدة بقدر ما تفتح أمامنا باباً للتأمل: أن الخوف قد يكون قراءة ناقصة للواقع، وأن الظلام لا يخلق الأشباح بل يسمح للأوهام أن تتكلم بصوت أعلى.
وأن النور حين يأتي، لا يُغَيَّر الأشياء، بل يعيد ترتيب علاقتنا بها، فنرى ما كان حاضراً دائماً، لكننا لم نكن مستعدين لرؤيته.