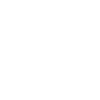التطرُّفُ… خيانةٌ لجوهرِ الأديانِ

بقلم: فاروق غانم خداجكاتب لبناني
وباحث في الأدب والفكر الإنساني.
عَبْرَ دروبِ التاريخِ، ظلَّ النُّورُ يُزاحِمُ الظَّلامَ، وظلَّت مَشاعِلُ الأنبياءِ تُضيءُ للناسِ سبيلَ الرَّحْمَةِ والعَدْلِ في وجهِ رياحِ البَغيِ والفِتْنَةِ. جاء نُوحٌ وإبراهيمُ وموسى وعيسى ومحمدٌ – عليهمُ السَّلامُ – ليُقيموا ميزانَ الحَقِّ، ويُطفِئوا نارَ الكراهيةِ، ويُعيدوا للإنسانِ كرامتَهُ الَّتي أرادها اللهُ له.
ومِن بعدِهم سار الصَّحابةُ والأولياءُ وأُولو الأَمْرِ الصالحونَ على النهجِ نفسِهِ: إصلاحٌ لا إفسادٌ، وإحياءٌ للقلوبِ لا إزهاقٌ للأرواحِ.
غيرَ أنّ في زمانِنا أصواتًا تتزيّن بزيِّ الدين وتتكلمُ باسمه، وهي في حقيقتها أبعدُ ما تكونُ عن هَدْيِهِ ومقاصِدِهِ. اتخذت من التَّحريضِ مذهبًا، ومن تشويهِ صورةِ الأديانِ الأخرى أداةً لإشعالِ النَّعراتِ، فابتكرت مضامينَ مختلَقةً، وأشاعت الكراهيةَ حيثُ كان ينبغي أن تسودُ المَحَبَّةُ، ورَسَّخت العداءَ حيثُ كان الواجبُ أن تُبنى جسورُ التَّعارُفِ. هكذا تتحوَّلُ الكلمةُ – وهي جسرٌ خُلِقَ للتواصلِ – إلى سِلاحٍ يُمزِّقُ النَّسيجَ، وتغدو المنابرُ التي وُجدت لذكرِ اللهِ منصّاتٍ لإقصاءِ عبادِ اللهِ.
وما شهدناهُ – بكلِّ أسى – في بعضِ مَشاهِدِ الساحلِ والسُّويداءِ في سوريا من قتلٍ للعاملينَ والآمِنينَ، ومن ذَبْحٍ وتمثيلٍ بالجثثِ، بل واقتلاعٍ لقلوبِ الضحايا، لا يمتُّ إلى أيِّ شريعةٍ بصِلَةٍ، ولا يرقى إلى رَحْمَةٍ ذكَرَتها الأديانُ.
تلك أفعالٌ تُجرِّدُ مُرتكبيها من إنسانيَّتِهم قبل أن تخلعَ عنهم ثوبَ الإيمانِ؛ إذْ إنَّ حُرْمَةَ الدَّمِ هي الحدُّ الفاصِلُ بينَ الحَضَارَةِ والهَمَجِيَّةِ، وبين دعوى التدَيُّنِ وحقيقةِ الدِّينِ.
وهنا تبرزُ مفارقةٌ مُرَّة: ما نسمِّيهِ العالَمَ الغَرْبِيَّ – الذي اعتدنا وصفَهُ بالصِّناعيِّ والمادِّيِّ – أظهرَ في مواقفَ كثيرةٍ رَحْمَةً وتسامُحًا يفوقانِ ما صدرَ عن بعضِ المتزيّينَ بزيِّ الدين وهم يقترفونَ أفعالَهم باسمِ الإيمانِ.
في ميادينِ الإغاثةِ، وتسييرِ الممرّاتِ الآمنةِ، واستقبالِ اللاجئينَ، وتطبيبِ الجِراحِ في مستشفياتٍ مفتوحةِ الأبوابِ، رأينا صورًا من الإنسانيّةِ غابت – للأسفِ – عن سلوكِ جماعاتٍ ترفعُ الشعاراتِ الدينيّةَ وتنفِّذُ العدوانَ. إنَّ الرَّحْمَةَ لا تُقاسُ بالشعارِ، بل بالممارسةِ والفعلِ؛ ولا تُختزلُ في لُغَةِ البياناتِ، بل تتجلّى في حفظِ النَّفسِ وإغاثةِ الملهوفِ وإطعامِ الجائعِ وكفِّ الأذى.
لقد حذَّر الأنبياءُ من الفِتْنَةِ، وأوصى الصَّحابةُ بكفِّ الأذى، ودعا أُولو الأَمْرِ إلى صيانةِ الدِّماءِ وإقامةِ العدلِ. يقولُ القُرآنُ الكريمُ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾، ويقولُ أيضًا: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾. وفي السُّنَّةِ الصحيحةِ: “ألا إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ”. وفي الإنجيلِ نداءٌ باتِّساعِ السَّماءِ: “طوبى لِصانِعي السَّلامِ لأنَّهُم أبناءُ اللهِ يُدْعَوْنَ”. هذهِ ليست نصوصًا للتجميل، بل مواثيقُ أخلاقيَّةٌ مُلزِمةٌ تُقِيمُ الحُدُودَ بينَ الشَّرِّ والخيرِ.
التطرُّفُ إذن انْحِرَافٌ عن روحِ الأديانِ، وتمرُّدٌ على مقاصدِها العليا: حِفْظُ النَّفْسِ، حِفْظُ الدِّينِ من التَّحريفِ، حِفْظُ العَقْلِ من التَّغريرِ، حِفْظُ المَالِ من النَّهبِ، وحِفْظُ العِرْضِ من الانتهاكِ. والمتطرِّفُ – أيًّا كان لباسُهُ – يخلُفُ هذه المقاصدَ خروجَ العاصفِ من أقفاصِ الرُّشدِ، فيحوِّل منابرَ الهدايةِ إلى محرابِ كراهيةٍ، ويستبدل الحُجَّةَ بالهُتافِ، والحِوارَ بالإقصاءِ.
إنَّ مواجهةَ هذا الانحرافِ مسؤوليّةٌ مُشْتَرَكَةٌ لا تُختَزَلُ في خُطبةِ جُمُعةٍ أو مقالٍ موسميٍّ. على العلماءِ أن يُبَيِّنوا للناسِ حَقائِقَ الدِّينِ بلا مُداهنةٍ ولا تسييسٍ؛ وعلى المفكّرينَ أن يَكشِفوا آليّاتِ التَّضليلِ الَّتي تستغلُّ جوعَ الأرواحِ إلى المعنى؛ وعلى الإعلامِ أن يُحاسِبَ خطابَ الكراهيةِ بدلَ أن يُسَوِّقَهُ تحتَ عنوانِ “السِّجالِ”؛ وعلى المربّينَ أن يَغرِسوا في النَّشءِ قِيَمَ الاحترامِ والاختلافِ الخلّاقِ، وأن يُعلِّموهم أنّ الهُويّةَ لا تقومُ على محوِ الآخرِ بل على التَّعارفِ معهُ والتَّكاملِ إلى جانِبِهِ.
ومِن واجبِ أُولي الأَمْرِ – سياسيِّينَ وقُضاةً وأهلَ إدارةٍ – أن يُقيموا العَدْلَ الذي يُطفِئُ نارَ الغُلُّ، وأن يُعاقِبوا المُحرِّضَ قبلَ أن يتحوَّلَ تحريضُهُ إلى دمٍ مسفوكٍ، وأن يَصونوا الفضاءَ العامَّ من الاستثمارِ في الغرائزِ الدُّنِيّةِ. فليسَ من العدلِ أن تُترَكَ المجتمعاتُ نهبًا لميليشياتِ الخطابِ؛ وليسَ من الحِكمةِ أن يُسْتَعمَلَ الدِّينُ وقودًا في ساحاتِ السِّياسةِ.
الدَّوْلَةُ العادِلَةُ لا تُعادي الدِّينَ، بل تحميهِ من التَّوظيفِ، وتَحمي المواطنينَ من التَّحريضِ والاقتتالِ.
إنَّنا بحاجةٍ إلى خطابٍ دينيٍّ مُستنيرٍ يُعيدُ تعريفَ التَّقوى بأنَّها رحمةٌ وصدقٌ وكفُّ أذًى، لا مظهرٌ وصياحٌ وإقصاءٌ. بحاجةٍ إلى تربيةٍ مدنيّةٍ تُحوِّلُ الاختلافَ من عُذْرٍ للخصومةِ إلى فرصةٍ للتَّكاملِ. بحاجةٍ إلى إعلامٍ يحترمُ الحقيقةَ، وإلى مناهجَ تُعلِّمُ الطلّابَ كيفَ يُفكِّرونَ لا ماذا يُفكِّرونَ.
وحينئذٍ فقط نَخرُجُ من ضَجِيجِ الشِّعاراتِ إلى سَكِينَةِ القيمِ، ومن صَخَبِ المزايداتِ إلى عملٍ يوميٍّ صبورٍ يُداوي الجراحَ بدلَ أن يَحثُّ عليها الملحَ.
ولن تخرجَ مجتمعاتُنا من هذهِ الدَّوَّامةِ إلّا إذا عادت إلى جَوْهَرِ الرِّسالاتِ، حيثُ الإنسانُ مُكرَّمٌ، والرَّحمةُ أساسُ التَّعامُلِ، والاختلافُ آيةٌ من آياتِ اللهِ لا ذريعةً للقتلِ أو الاقتلاعِ.
عندها فقط، سنكونُ أوفياءَ لرسالةِ الأنبياءِ، وسنستحقُّ أن نُدعى أبناءَ السَّلامِ؛ فالسَّلامُ ليسَ هدنةً عابرةً بين حربين، بل هو نِظامُ قِيمٍ يَحمي الحياةَ من عبثِ المُتَطَرِّفينَ، ويَفتحُ للإنسانِ بابًا واسعًا على كرامتِهِ الَّتي خُلِقَ لها.
@جميع الحقوق محفوظة